لماذا التقمّص؟
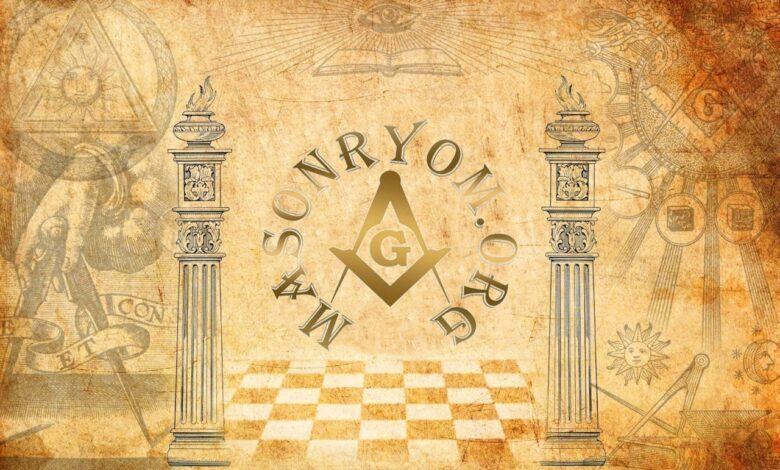
“قال له أتباعه، متى تحدث راحة الأموات، ومتى يأتي العالم الجديد؟، فقال لهم (السيد المسيح) ما تبحثون عنه قد أتى لكنكم لا تعرفوه”
وهذا يعني أن البعث والملكوت موجودان هنا على الأرض، لكننا لا ندركهما، أو وفقاً لمفهوم الحكمة القديمة، لم نتكامل بهما بعد
إن الإيمان الحقيقي لا يمكن أن يُبشّر به، والعلم الحقيقي لا يمكن أن يكتسبه المرء أو يُقنع به الآخرين. والحكمة ترسخ في النفوس عبر لغة النور، وعين النور (هرمس الأنفس) هو صاحب المنظار الفريد الذي لا يمكن تركيبه أو شرحه إلا بالإثبات المنقطع النظير فهو كأثير الضوء ينشغل عنه الناظر بالأشياء التي يضيئها ولسان الصدق في التعبير عن جوهر النفس في كل زمان ومكان.
لذلك، إن القلب ينفر تجاه أي محاولة علمية لإثبات عقيدة التقمّص أو أي لجوء للغموض المقصود وإسلوب الإثارة لجذب انتباه الآخرين للتقمّص. وإنه لمن الطبيعي لأهل الحكمة أن تلهم عقيدة التقمّص أفعال الحكيم وتصرّفاته في أبسط أمور الحياة، وليس من الطبيعي أن تصبح موضوع نفي أو إثبات.
لهجة الزمان قد تغيّرت لأحباب الحكمة بعد أن خُتِم على ميثاق زواجهم الأبدي بالسعادة دين ودنيا، ومَن صحّت ديانته صحّت دنياه، فلا يبرّر حبّه بالألم والمعاناة، ولا يتلذّذ بقول “آه” بينما يرى سعادة الآخرة تُصلَب على خشبة الدنيا بل ينهض ويدافع عن حقّه فتتم سعادته في دنياه وآخرته،
والمحمّل بالسكون في أسلوبه يتجاوز عاصفة المحبوب فالحبيب لا يضع نفسه موضع الدفاع عن محبوبه، ولا يفصح عن أسباب حبه للحسّاد والمتطفّلين، إنما يتغنّى بِمَن يحب بفرح وسعادة، فـ
“لا تواضع أو استكبار، لا تراخي أو تمايل للستار”.
إن عقيدة التقمُّص لأهل الحكمة مبنية في الأساس على الواقع، والواقع بطبيعته ليس موضوع إثبات أو نفي، فهو كالحضور بالنسبة للغياب، التقاؤهما ضرورة فكرية فقط ولاكتمال أوجه المعرفة لا أكثر، أما في الحقيقة فالحضور ينفي الغياب نفياً مطلقاً وحقيقة هذا النفي بديهية.
وعلى قدر ما تتوجّه النفس إلى هذه الحقيقة تبقى في حالة توحّد مع الواقع ولا تخضع لتقسيمات الفكر.
ومعطيات الواقع تقول: إن الروح لا يمكن أن توجَد أو تُعرَف أو تعبّر عن معرفتها أو تُثاب أو تُعاقَب من غير آلتها (أي الجسد)، وهذا بديهي أيضاً، فوجودها في هذا الجسد هو ببساطة أصدق تعريف عن الإرادة الإلهية لمصير الروح الآن وفي كل زمان، لأن ما تراه العين الآن عن طبيعة تواجد الروح هنا في عالم الأجساد أصدق ممّا يتصوّره الفكر عن تواجدها في زمن مجهول في عالم مجهول، ولولا اعتراف الإنسان الحدسي بهذه الحقيقة البسيطة لما جاهد الإنسان أصلاً لتحقيق شيء على الأرض رغم معرفته المسبقة بأنه سيموت.
فها هي الروح هنا والآن تثبت اقتران أبديتها بعالم الأجساد عبر التقمّص، فهل من أبدية آخرى للروح يمكن أن يتصوّرها العقل دون تصوّر الزمان والمكان أو الممكن والإمكان؟
أليس كل ممكن ممكن لأنه ممكن الحدوث؟
وأليس كل حادث يحتاج إلى تسلسل زمني يعبّر عن البنية المعنوية للحدث؟
أم أن للحدوث قانون في عالم آخر يختلف عن قوانين الحدوث في هذا العالم؟
وبأي صلة سيتّصل هكذا قانون بأحداث هذا العالم؟
وعلى ماذا سيُثاب أو سيُعاقَب الإنسان في العالم الآخر، على ما يفوق قدرة عقله على تصوّره في هذا العالم؟ وهل هذا هو متّسع قانون العدل الإلهي؟
وما هو ذلك المنطق الذي من شأنه أن يُخضِع أعمال الإنسان في هذا العالم لمقاييس الحكم في العالم الآخر؟
وإذا كان ذلك العالم الآخر عاجز عن دخول نطاق المعرفة أو الخضوع لمقاييسها، لما الثواب والعقاب أصلاً، ولما الدخول في نطاق المجهول وتصوّر ما هو غير موجود؟
أم أن للأبدية شكل لا يصبح أبدياً حقاً إلا بانعدام صلته بأشكال هذا العالم؟
والله لا يصبح الله حقاً إلا إذا تخلّص الإنسان من أي صلة تربطه بالألوهية في هذا العالم كما هو الحال اليوم في عالم الفوضى والإهمال الغارق في الشرور والمآسي؟
ولما هذا الاستعداد لنفي صورة الأبدية من هذا العالم من جهة، والعجز عن تصوّر الأبدية دون اللجوء إلى قوانين هذا العالم من جهة أخرى؟
لما هذا الاستعداد لنفي وجود الله من هذا العالم قولاً وعملاً من جهة، وتحميل الله مسؤولية ما يجري في هذا العالم كلّما اشتد الزمن وضاق على فهم الإنسان منطق الأحداث من جهة أخرى؟
لما هذا الرفض لقدسية الإله في آدم وآدم في الإله، لما هذا الجحود لحكمة:
“كنت كنزاً مخفياً، لا أُعرَف، أردتُ أن أُعرَف فخلقت الخلق وبي عرفوني…”
و”لمّا كان الخلق مولودين جهالاً لا يعرفون إلا بموقوف ومعروف أوجبت الحكمة ظهور الصورة…”
“ولولا الدنيا والآثار لما بدت الأسرار…”
وبكلامنا هذا نحن لا نحاول إثبات عقيدة أزلية الروح في هذا العالم، بل اننا نتغنّى بهذه الحكمة. لأن:
“الفتاة الجميلة قد مكثت في غرفتها حيث لا أحد يراها تنظر إلى جمالها في المرآة لزمن طويل، لكن للجمال ثورة…”

